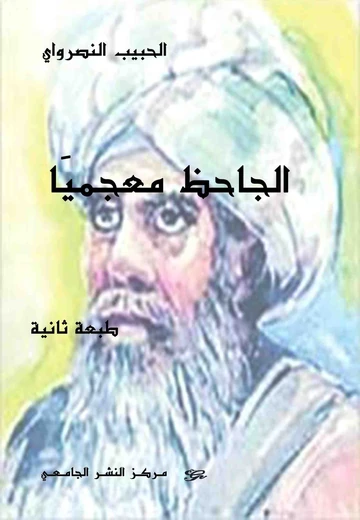الجاحظ معجميا
Détails de la publication
| Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|
| التمهيد | 15 | 58 | Published | |
| الفصل الأول : الفصيح | 59 | 124 | Published | |
| الفصل الثاني : المولد | 125 | 198 | Published | |
| الفصل الثالث : العامي | 199 | 230 | Published | |
| الفصل الرابع : الإقتراض | 231 | 270 | Published | |
| المصادر | 299 | 299 | Published | |
| المراجع العربية | 300 | 304 | Published |
الجاحظ معجميا
Préface
هذه دراسة لسانيّة معجميّة لجوانب من مواقف الجاحظ اللغوية؛ ومن آرائه في التطوّر اللغوي، وفي علاقة المنوال بالاستعمال، وبتقاطع التاريخ مع النظام، وأثر كلّ ذلك في واقع اللغة العربية بين الممكن اللغوي ودور المتكلّم في تكييفه مع المقام، وبين الرّصيد المنجز، ودور المعجم في الدفاع عن استقراره أو انغلاقه.. لكنّ الاستقرار الذي يراد للغة ظاهره حماية خصائصها، وباطنه منهج يفرض في النّهاية المعيار على الاستعمال ويجعل وظيفة المتكلّم خارج التّاريخ، ممّا يعمّق الهوُّة بين اللغة ومعجمها. فإنّ من اللغويين من كان يرى أنّ من واجبه أن يحفظ من الانحلال الشّكل اللغوي المتّفق على فصاحته. وهذا ما يؤدّي إلى ظهور عدّة ملاحظات في إطار التّمييز بين اللسانيات الوصفية .( والنّحو المعياري( 1 وقد ساعدهم ذلك على الفصل بين المستعمل والممكن في اللغة، فعالجوا قضايا التّطوّر في اللغة على أساس الصّلة بين الأصل الفصيح والفرع المحدث. وهذا نحو من التّناول لا يرفع الفواصل بين الدّوالّ ومدلولاا القديمة وما آلت إليه في الاستعمالات الجديدة. فنتج عن ذلك نفي الميزة الحيو يّة للغة العربية. وحاجة العربية إلى التعبير عن مفاهيم حضارية واجتماعية وثقافية مستحدثة. وهو ما أدّى إلى تجاهل التّطوّر في اللغة واعتباره حلقات منفصلة .( عن مسار اللغة( 2 ولا تزال العربية إلى اليوم تعاني من آثار هذا الفصل بين الواقع والنّموذج المفروض باسم الفصاحة، وحماية لغة القرآن. ونلاحظ أنّ ذلك قد آل إلى انفصام شديد بين العربية المشتركة، ونعني ا عربية الكتابة والتعليم، والعربية المقولة التي يتحرّر فيها المتكلمون من كلّ قيد، فتطغى لغة جديدة أو تكاد. لذلك رأينا أن نبحث في هذه القضيّة انطلاقا من أسس نظريّة تثبت قيام الوحدة المعجمية على مفهوم التّطوّر أساسا، رغم الاستقرار الظّاهر في مستوى النّموذج؛ ثمّ تمّ بمعالجة معجميّة تاريخية لنماذج من نصوص أساسيّة في تاريخ العربية، مثّلت شكلا من أشكال القول في أزهى عصور العربية وأكثرها عطاء –أعني مؤلفات الجاحظ- قصد البحث في درجة الالتزام بالفصيح أو العدول عنه، لنصل ذلك بمسألة التوليد المعجمي في عربية الإنتاج العلمي والإبداع الفنّي، وكيف تعاملت مع ذلك الواقع بما يتداخل فيه من جديد وقديم وعاميّ وأعجميّ .. عملا بالمنهج اللغوي التاريخي، فإنّ الاعتماد التاريخيّ ، في هذا اال، يعيننا على معرفة محطات القضية ومفاهيمها المتنوّعة. ومعنى هذا أنّنا سنهتمّ بالنّواحي البيئية والتاريخية التي يمكن أن تفيدنا في تحديد ملامح التّطوّر اللغ وي في العربية، ذلك أنّ وصف التّطوّر اللغوي يمكن إذن أن يتأسّس جزء منه على وصف السّياق التاريخي لتولّد الكلمات الجديدة، وعلى طبيعة المتكلّمين الذين أنتجوها ومجالات التجارب التي ظهرت فيها. وهكذا يكون هذا التّصنيف اجتماعيا تاريخيا كما هو في نفس الوقت لغويّ . فهو يستعين بمقارنة المراحل الزمانية المشتركة لتاريخ اتمع وتاريخ المعجم. ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى تحديد حركات المولّدات اللغوية في علاقتها بتقلّبات المرجعية التاريخية. فهناك ضرب من الكلمات يموت وآخر يظهر وثالث يختفي ثمّ يعود في شكل عملية توليد جديدة إلخ. لذا ليس من الغريب أن نجد في هذه العربية المو لدة تغيّرا كبيرا. وكان من المفروض أن تظلّ قوائمها منفتحة على التجربة الإنسانية، بما أّا تعكس متواصلا من البنية الحاصلة في اللغة إلى بنية التجربة غير المنتهية التي للإنسان .( عن الكون( 1 وعلماء العربية أنفسهم لم يستطيعوا منذ القديم إنكار أهم يّة ذلك التوليد في واقع العربية، فتحدّثوا عن اتّساع مفردات اللغة ممّا يتطلّب تقصّي الجديد من المعاني وقدرات الدّ لالات الفصيحة على أدائها. وهو ما انعكس أيضا في المعجم، فسعى في التعريف إلى إيراد أكثر من دلالة، ممّا ينمّ عن معالم تطوّر دلاليّ، لكن دون الانشغال بالبحث في قوانينه العامة. ومع أنّ متابعة التّطوّر اللغوي والدّلالي أمر ميسور في اللغات الحيّة، فإنّه في العربية ليس كذلك. ونحن نلجأ عند الدرس التاريخي إلى النّصوص القديمة للبحث في مظاهر تطوّر ألفاظ العربية في غياب معجم تاريخيّ نحتكم إليه في تحديد مراحل التطور وعوامله ومظاهره. وقد أردنا ذه الدراسة أن نثبت أمرين: - الأول الاستناد إلى مصدر من أهمّ مصادر العربية لنثبت أنّ قضايا التطور اللغوي والاستعمال والمستويات اللغوية والاقتراض، وغيرها. حقائق لغوية لا غنًى للغة عنها؛ - والثاني تأكيد الحاجة إلى معجم تاريخيّ للغة العربية للتخلّص من نزعات التطرّف والتوقّع والتّخمين. وهو ما يخلّص العربية ممّا ران عليها من أزمنة الضعف وأخفى ما قامت عليه حقيقتها من حريّة واستجابة للواقع في نطاق قوانينها وقواعد التوليد فيها. أمّا اختيار الجاحظ فيعود في نظرنا، إلى أنّه واحد من أكبر ناثري العربية، وأغزرهم إنتاجا، وأكثرهم إلماما بخصائص النّثر العربي فصيحه ومولده.. وفي نصوصه إدراك واضح لهذه المستويات سواء من حيث الإشارة المباشرة إليها، أو من حيث الحاجة إلى استعمالها في نصوصه، حسب طبيعة الخطاب. إضافة إلى ما تميّز به عصره، من تجدّد فكريّ، وتحرّر لغويّ، واختلاف اجتماعيّ، وصراع مذهبيّ .. ولذلك انعكاسه المباشر في مستوى اللغة المكتوبة خاصّة بسبب تصدّيها للفكر الجديد وما يتنزّل فيه من قيم ومفاهيم لا عهد للثقافة العربية ا، وليس لها في عربية البدو ما يّعبّر به عنها. لهذه الأسباب رأينا أنّ مؤلفاتِ الجاحظ مادّةٌ ثريّة تيسّر عمليّة البحث والتحليل، وتفيد في كشف الواقع اللغوي، ومن ثمّ استنباط آراء والوصول ربّما إلى أحكام واستنتاجات. أمّا من النّاحية العمليّة فقد تميّز الجاحظ بمعالجته للقضية اللغوية في مختلف مؤلفاته، وذلك من زاويتين: أ- الأولى زاوية نظريّة: فقد بثّ الجاحظ في أغلب ما ألّف، مجموعة كبيرة من الآراء اللغوية بعضها ذو بعد لسانيّ عامّ كقضايا التطوّر اللغوي، ومسألة اللفظ والمعنى، والمستويات اللغوية..؛ وبعضها خاصّ بالعربية من حيث هي اللغة المدركة بالقول، المستعملة بالفعل في ما يكتب، فبحث في ما طرأ عليها من تغيّرات، وما شهدته أبنيتها من طول تصرّف بحسب المقام والظرف التاريخيّ والاجتماعيّ ..؛ ب- الثانية زاوية تطبيقية: فإنّ الجاحظ لم يكتف بالتعبير عن قناعاته ومواقفه اللغوية تنظيرا بل مارسها فعليّا في مستوى الكتابة والتّأليف. فقد جاءت لغته قائمة على حقيقة التطور، فلم يكرّس معجمه للفصيح وحده، بل آثر لغة الاستعمال، وترك للمتكلم حرية اختيار المستويات اللغوية المناسبة لكلّ مقام. وقد أغرانا ذلك بتتبّع آراء الجاحظ وممارساته اللغوية في أهمّ مؤلفاته لنستخرج منها معجمًا هو الذي أقمنا عليه هذه الدراسة. فقد خصّصنا التمهيد للجانب النظريّ واهتممنا فيه بدراسة الجوانب اللسانية في فكر الجاحظ التي انطلق منها لبناء مفاهيمه اللسانية العامة: كاختلاف اللغات باختلاف تجارب المتكلمين، ومسألة التطوّر والبلى وفق الحاجة والاستعمال، وقضايا تعدّد المعنى وغموضه ومحدودية الألفاظ، ومسألة الثّابت والمتحول، والحاجة إلى المستويات اللغوية لتنوّع أركان الخطاب. ثم تناولنا في الفصول الأربعة بالدّ رس والتحليل المستويات اللغوية التي قامت عليها مؤلفاتُ الجاحظ، وهذه في الحقيقة مستوياتٌ لغويةٌ لا تخلو منها لغة حيّة، فإنّ جميع اللغاتِ تنطلق من الفصيح باعتباره الأصلَ، لتتّسع إلى ما يحدثه المتكلمون:إمّا بقواعد التوليد الطبيعية، فهو مولّد، وإمّا بتحريفه صوتيّا أو صرفيّا أو تركيبيّا أو دلاليّا فهو عاميّ، وإمّا باقتراضه من لغات أخرى فهو مقترض. وقد عالجنا هذه المستوياتِ من زاويتين كذلك: أ- الأولى اعتمادا على آراء الجاحظ في كلّ مستوى من المستويات المدروسة، من حيث أهميّته وضرورته في الخطاب، ومقارنته بغيره من المستويات، وموقفه منه من جهة الفصيح وغير الفصيح..؛ ب- الثانية استنادا إلى درجة اعتماد الجاحظ على كلّ مستوى بعينه في كتاباته، ولذلك استخرجنا معجما معبّرا عن كلّ مستوى يثبت موقف الجاحظ من ناحية، ويؤكّد ضرورة الاعتماد على هذه المستويات باعتبارها مكوّنات أصيلة في واقع العربية منذ مراحلها المتقدّمة. وقد قصدنا بذلك بيان أهميّة الإقرار بالواقع اللغوي بعيدا عن التّصنيفات المعيارية التي تدين جزءا من مكوّناته وتعتبره هباء منثورا، وتدعو إلى التخلّص منه، وكأنّ اللغة يمكن أن تستقيم بإهمال أغلب مكوناا (أي المولّد، والعامي، والأعجميّ )، والاقتصار على مكوّن واحد وهو المعروف بالفصيح. فإنّ ذلك عاجز عن نقل التجارب الحادثة في واقع المتكلمين، ولن يستطيع أن يصهر ما تملكه اللغات الأخرى من مفاهيم وأشياء لا وجود لها في اللغة الأصليّة. إنّ العودة إلى تجربة الجاحظ تدعونا اليوم إلى التأمّل في واقع اللغات جميعا، وفي سبل نموّها وتجاوز مظاهر ضعفها وتخلّفها، والوقوف على رؤية لسانيّة بلغت بالعربية ما بلغته عصر ازدهارها، فطُوعت للتجديد وللتّوليد فاستجابت. فإنّ ما قدّمه الجاحظ على ما فيه من تجاوز لخصائص الفصحى وإقرار بما جدّ في حياة الناس من جديد - فلم يتحرّج من استعماله- لم يُسِئْ إلى العربية، ولم يُهدّدْ بقاءَها، بل إنّ ما أنجزه كفيلٌ بأن يكشفَ أنّ الواقعية اللغوية كما فهمها الجاحظ، وسيلة ضروريّة لحماية اللغة وبقائها معبّرةً عن مشاغل الناس حاميةً لأسس الماضي، آخذةً بأسباب الحاضر، قادرةً على التواصل مع المستقبل. أمّا اشتراط الصّفاء اللغوي باعتماد مستوى واحدٍ بعينه فهو من آراء اللغويين المتشدّ دين فرضوه على النّحو والمعجم، دون أن يكونوا هم أنفسهم قادرين على الدفاع عنه، فضلا عن تكريسه في الحياة العامة. ولكنّ المعجم العربيّ يظلّ مع ذلك ثابتًا، لا ينَْزِل من عليائه إلا قليلا، فلم يتجرّأ حتى على أن يكون بجرأة معجم الجاحظ بما حواه من مولّد وعاميّ وأعجميّ، وما استقبح ممّا سمّاه تَوعرًا، من فصيح مهجور، أو لغات عفا عليها الزمان، وليس لها من فضل إلا البداوة.. فشرح بعضه ودعا إلى تجاوز بعضه الآخر بسبب انتفاء الحاجة إليه. وفي هذه الدراسة تحليل لهذه القضايا التي أثرنا بالاعتماد أساسا على معجم استقيناه عشوائيّا من مؤلفات الجاحظ، دون أن نجاوز به حدّ النّموذج الممثل إلى الرصيد الشامل. فإن الحديث عن "معجم الجاحظ" عمل يجاوز حدودَ هذا البحث وأغراضَه.
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|