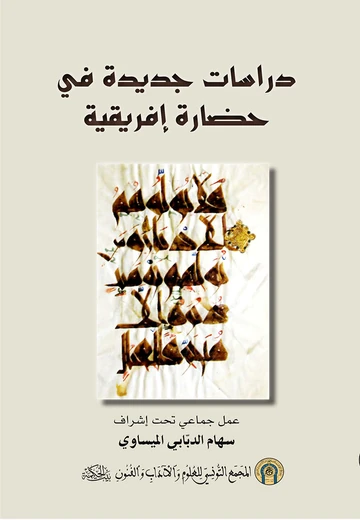Mots clés
دراسات جديدة في حضارة إفريقية
Détails de la publication
| Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|
| مقدمة | 7 | 14 | Published | |
| أعياد إفريقية بين أحكام الفقه وعادات الناسّ | 15 | 74 | Published | |
| صور من العلاقات الاجتماعية في العصر الوسيط: مقاربة تفاعلية | 75 | 118 | Published | |
| تفاعل الفئات في المجتمع الإفريقي: مقاربة سوسيولوجية لنماذج من العهدين الأغلبي والفاطمي | 119 | 152 | Published | |
| كتاتيب افريقية : قراءة في المأسسة وآداب السلوك | 153 | 186 | Published | |
| نصارى افريقية : قراءة في منزلتهم الاجتماعية | 187 | 224 | Published | |
| نظام اللباس بإفريقيةّ | 225 | 262 | Published | |
| أصداء إفريقية في «لسان العرب»: بحث في المسألة المذهبية | 263 | 286 | Published | |
| من إسهام إفريقيةّ في الحركة الصوفيّة | 287 | 336 | Published | |
| الكرامة الصوفية من خلال «معالم الإيمان» للدباغّ | 337 | 366 | Published | |
| ّصورة المع بن باديس في المصادر التاريخيةّ | 367 | 394 | Published | |
| كتابة الألم في رثاء علي الحصري | 395 | 442 | Published | |
| اللهو في أدب إبراهيم الحصري | 443 | 468 | Published | |
| أدب الباه: مصادر المعرفة وااجاهات التأليفّ | 469 | 536 | Published |
«دراسات جديدة في حضارة إفريقيّة» مؤلَّف جماعي تعمّق المساهمون فيه، من أساتذة الحضارة العربيّة والإسلاميّة بالجامعة التونسيّة، في مصادر الفقه والفتوى والتراجم والتاريخ والتصوّف واللغة والأدب شعرا ونثرا فقاربوا نصوصها مقاربات جديدة توظّف المناهج الأنثربولوجيّة والسوسيولوجيّة ومناهج تحليل الخطاب.
Préface
إفريقيّة مجال درس خصيب، مصادره معين لا ينضب، عُنــِـيَ بعض المستشرقين بدُولهـا ومؤسّساتها الدينيّة والاجتماعيّة ومدنها و عمارتها وعُملتها... وبعض أعلامها مثل ابن خلدون (ت 808هـ/ 1406م). واهتمّ الجيل المؤسّس للجامعة التونسيّة بتاريخها السياسي والاقتصادي وبإنتاجها العلمي والأدبي والنقدي والفقهي درسا وتحقيقا. وسار طلاّبهم على دربهم فحقّقوا ما لم يحقّقه أساتذتهم من نوازل وفتاوى ومناقب ورسائل وآثار في الطبّ، وعمّقوا البحث في الشعر والبلاغــة والتصوّف والجدل الديني والفقه المالكي والجغرافيا التاريخيّة وتاريخ العمارة والفنون والتاريخ الاجتماعي واهتمّ بعضهم بالميكرو-تاريخي متأثّرين بموضوعات الأنثروبولوجيا التاريخيّة ومناهجها. وإن واصل المؤرّخون والمختصّون في الدراسات الإسلاميّة البحث في تراث إفريقيّة الديني، وفي تاريخها فإنّ قراءة نصوصها وتأويلها من قبل المختصّين في اللغة والآداب والحضارة العربيّة قد تراجعا، وتحقيق ما بقيَ من المصادر غير المُحقّقة قد نَدُر. وقد قادتنا رغبة ملحّة في إحياء سنن حميدة لازمت طويلا الدراسات العربيّة التونسيّة، ودفعنا الوعي بقيمة مساهمة أبناء جيلنا وطلاّبنا في دراسة حضارة إفريقيّة إلى تأليف عمل جماعي تُتْرك الحرّية للمساهمين فيه بأن يدرسوا ما شاؤوا من المواضيع وأن يختاروا ما يرونه ناجعا من المناهج على أن يكون التجديد في المقاربات هاجس كلّ باحث. وقد رأينا أن نهتمّ بالاحتفالي في مقال عنونّاه بـــ«أعياد إفريقيّة بين أحكام الفقه وعادات الناس». يهمّنا فيه المظهران الرسومي واللعبي للعيد، ويفيدنا البحث في بُعْديه المفارق والاجتماعي وفي عناصره المقدّسة والدنيويّة وثوابته وقطائعه. وقد خامرتنا أسئلة كثيرة عند قراءة المصادر الإفريقيّة، منها كيف يساهم المقدّس في بناء الجسد الاجتماعي الاحتفالي؟ وكيف يتمّ تقويض الواقع اليومي الرتيب لإعادة بنائه ولامتلاك الحياة اليوميّة؟ وكيف يساهم العيد في بناء الهويّة الثقافيّة وترسيخ الاختلاف؟ وهل يكون في العِيد لَهْوٌ رغم نهي الفقهاء عنه؟ وكيف يُطَقْسَنُ اللعب حتّى يُراقَب الهيجان وينظَّم التجاوز ويُجلَى القانون؟ وكيف يستوعب السياسي العيد؟ ولا شكّ في أنّ المقاربة الأنثروبولوجيّة هي التي تسمح بالتعمّق في دراسة العيد نسقا طقسيّا وتفكيك عناصره ووحداته الدنيا وتحليل رموزها. لا تقلّ دراسة الحياة اليوميّة أهميّة عن الاحتفاليّة. ولمّا كان التفاعل الاجتماعي مكوّنا للمجتمع وأُسّا بانيا لليومي وعنصرا محدّدا للعلاقات الاجتماعيّة، ضمّ هذا المُؤلّف الجماعي مقالات تهتمّ بهذا البعد. فلقد انطلقت زهيّة جويرو من الفتاوى لدراسة «صور من العلاقات الاجتماعيّة بإفريقيّة في العهد الوسيط» واختارت مقاربة «تفاعليّة» سمحت لها بمجادلة السائد وتقويض أفكار تتعلّق بتمثّل منزلة المرأة الإفريقيّة. فإن كان تفاعلها مع زوجها لا يخلو من «انحرافات» و«انتهاك لمجال الذات» وإخضاع فإنّ الواقع يكشف حرصها على حماية نفسها و«الحفاظ على ماء وجهها» وتصحيح للانحراف وتجنّب للهيمنة الذكوريّة. ولم تكتف صاحبة هذا المقال بالبحث في علاقة الزوجين بل توسّعت فدرست تفاعل الأبناء والآباء، والعالم والمتعلّم، والعالم والعامّي، والمالك والعامل، لتبيّن أنّ العلاقات الاجتماعيّة محكومة بالواقع الذي يبنيه الفاعلون، وأنّ الدين ليس إلاّ محدّدا من المحدّدات المساهمة في هذا البناء الذي يميّز إفريقيّة وإسلامها. ولم تخْلُ مقاربتها من توظيف لأنثروبولوجيا الأديان. وارتأت فريدة طراد أن تقارب «تفاعل الفئات الاجتماعيّة في العهدين الأغلبيّ والفاطميّ «مقاربة سوسيولوجيّة» غوفمانيّة مهتمّة بشكلين من التفاعل: شكل «الانحرافات» وشكل «النشاط المصلح» أو الإلغاء الطقسي لتأثير هذه الانحرافات السلبي. فأمّا الشكل الأوّل فقد سمح بتحليل ما جاء في بعض النصوص من إخلال بــ«الطقوس الإثباتيّة» ومن انتهاك لــ«مجالات الذات» وتشويش للقواعد وإخلال بالتفاعل وتهديد لــ«ماء الوجه». وأمّا «النشاط المصلح» المدروس فيُــــبــــــيّنُ وضعيّات ترميم التفاعل وتسوية معالم الانحراف وتصحيحها حفظا لــ«ماء الوجه». تفيد دراسة التفاعل الاجتماعيّ بمعرفة القيم والأخلاق والمعايير والأدوار والتّمثّلات التي تحكم العلاقات الاجتماعيّة «الباردة» و«الحميمة». وقد يكون فضاء التفاعل ركحا محدّدا لأداء الأدوار. ولقد ساهم الفقه في نمذجة (typification) الفاعلين وقواعد تفاعلهم في الأفضية العامّة والخاصّة. ومن أفضية التفاعل اليوميّة الكتاتيب التي خصّها نادر الحمّامي بالدرس معتنيا بموضوعَيْ «المأسسة وآداب السلوك» أي طقوس التفاعل، انطلاقا من كتابي: محمّد بن سحنون (ت 256هـ /854 م) في آداب المعلّمين والقابسي (ت 403هـ/1012م) في أحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين. ونظر الباحث في منزلة المعلّم في إفريقيّة وقارنها بمنزلته في المشرق، وقد أفاد هذا البحث بمأسسة الكتاتيب إذ قُنّنت وظيفة المعلّم ونُظّم فضاء التعليم وضُبطت آداب السلوك وطرق التعليم وموادّه وكيفيّة التأديب والرقابة والعقاب. ومن الفئات التي اهتمّ بها هذا المؤلّف الجماعي «نصارى إفريقيّة»، فقد اختارت سماح حمزة موضوع الآخريّة والمقاربة التاريخيّة لتقدّم قراءة في «منزلة النصارى» وحياتهم. ورغم صعوبة الحديث عن نصارى إفريقيّة لشحّ المصادر بالمعلومات عنهم، فإنّ الباحثة بيّنت مساهمة هذه الفئة في تكوين المجتمع الإفريقي مفكّرة في أصولهم ومذاهبهم ووضعيّاتهم الشرعيّة. ولم يخل هذا البحث من المقارنة بنصارى المشرق طلبا للخصوصيّة الإفريقيّة. ولقد ارتأت أن تنطلق من فقه إفريقيّة وفتاويها لتتعمّق في مسائل الحريّة والرقّ وشرب الخمر ولباس «الغيار»، وانتهت إلى أنّ واقع التعايش والسلم لا يبدو دائما متأثّرا بالحدود التي يبنيها الفقهاء بين المسلم وغير المسلم. ولم يفت هذا المؤلَّف الجماعي أن يولي اهتماما بنسق فرعيّ من أنساق اليوميّ وهو اللباس الذي اهتمّت زينب التوجاني بنظامه في إفريقيّة. فاللباس مظهر من مظاهر الثقافة، ينتظم فيها انتظاما دالاّ شأنه في ذلك شأن اللغة. وقد سمحت المقاربة السيميائيّة البنيويّة للباحثة بأن تفكّك الوحدات الارتدائيّة (vestèmes) وأن تبــحث في عناصرها الفرعـــــــيّة المكوّنة لنسق كلّي. وقد وظّفت مقولات اجتماعيّـــة، وأنثروبولوجيّة ربطت بين اللباس وأنماط العيش وأساليب الحياة والهويّة الاجتماعيّة والثقافيّة وإنتاج الجسد الاجتماعي والجسد الديني والجسد السلطوي، منتهية إلى أنّ اللباس مظهر من مظاهر التعاقد الاجتماعي، مبرزة الخصوصيّة الإفريقيّة. لا تخلو المدوّنة الإفريقيّة التي درست المظاهر الاحتفاليّة و التفاعلات الاجتماعيّة وحياة الفئات ومنزلتهم والأنساق اليوميّة من حضور الدّينيّ والإيديولوجيّ في تصوّر المجتمع وتمثّل جماعاته وأفراده. ولا يقتصر البعد الإيديولوجيّ على نصوص الفتوى والفقه والتراجم والتاريخ بل نجده أيضا في الخطاب العلمي. فقد سمحت فلسفة الخطاب لناجية الوريمي بأن تدرس العلاقة بين تشكيل الخطاب المعجمي الإفريقي والاسترتيجيّات الإيديولوجيّة الموجّهة لدلالاته، فبيّنت في مقال عنونته «أصداء إفريقيّة في لسان العرب بحث في المسألة المذهبيّة» تشبّث ابن منظور (ت 711هـ/ 1311م) بالأصول المرجعيّة الدينيّة أكثر من المعجميّين المشارقة. فقد سمح له منهجه الانتقائي ومادّة الحديث والفقه والكلام المبثوثة في شروحه، والسجلّ السياسي الوارد فيها بأن يدافع عن مقولات السنّة ويتحامل على الخوارج ويتعامل تعاملا مخصوصا يتعاطف فيه مع رموز الشيعة، حتّى أنّ المشارقة عدّوه شيعيّا. فكان الرجل سنيّا على طريقة إفريقيّة. وطبيعيّ أن يهتمّ كتاب في حضارة إفريقيّة بظاهرة روحيّة ظهرت في البلاد وانتشرت. لذلك خصّص محمّد بالطيّب مقالا في «إسهام إفريقيّة في الحركة الصوفيّة» درس فيه بعض ملامح البعد الروحي من خلال نماذج من سير صلحاء إفريقيّة وأخبار زهّادها وعبّادها مبيّنا طريقة تمثيل مصنّفي التراجم للسلوك الصوفي ومقوّمات صورة الكمال الإنساني وعناصر التجربة الصوفيّة. ولم يكتف المؤلّف بالسلوك الصوفي الجامع بين العلم والعمل والمنخرط في المجتمع، بل اعتنى بإسهام إفريقيّة في التنظير منطلقا من كتاب الدبّاغ (ت 696 هـ/ 1296م) مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب الذي وجد فيه إشراقيّة. وقد لفتت الكرامة الصوفيّة في كتاب معالم الإيمان للدبّاغ (أكمله ابن ناجي ت 839هـ/ 1435م) بلقيس الرزيقي التي درست تمثيلات حيوات رجال امتزج فيها الواقعي بالخيالي. وكان لكرامتهم أبعاد رمزيّة ومتخيّلة وسحريّة ودينيّة. ولقد لاحظت أنّ الكرامة حدث عجائبي صادر عن شخصيّة كاريزماتيّة يُعتقد في قدرتها الخارقة وفي صلتها بالبركة، قُوّةِ المقدّس النافعة. واختارت الباحثة تحليل كرامات العطاء وقضاء الحوائج والدعاء المستجاب، وطيّ الأرض. وساعدها اختصاصها في تاريخ الأفكار الدّينيّة على تحليل رموز وردت في الأمثلة التي انتقتها ومن مسائل التمثيل الهامّة البحث في صورة السلطان في الخطاب التاريخي. وهذا موضوع أشار على حنان بالشاوش بأن تأخذ أنموذج حاكم عرفت إفريقيّة في عهده أوج ازدهارها، إنّه المعزّ بن باديس (406 هـ - 454هـ/1016م - 1062م). ويعود اختيار صورة هذا السائس إلى أمور منها أنّه بُويع حدثا فكان حاكما صبيّا ذا عصبيّة قويّة وذا سند نسائي هامّ تمثّل في شخصيّة أمّ ملال (ت 414هـ/1023م) عمّته، ومنها أنّه تُمُثِّل سلطانا حليما حازما محاربا قادرا على عقد الصلح مع الأعداء، وزعيما سنيّا قطع دابر الشيعة وقاطع القاهرة، ومنها أنّ خَطْبًا أليما نزل على إفريقيّة في آخر عهده (غزوة بني هلال)، تراجع بالبلاد. وفي هذا المقال بحث في صور متعدّدة لحاكم بارز وصور النساء اللائي أحطن به، وإظهارٌ للفعل السياسي الذي يحتاج إلى القوّة والكيد ومشهدة السلطة والبذخ. وقد اُحتيج في هذا المقال إلى توظيف مفاهيم اجتماعيّة وأنثروبولوجيّة حديثة تُعمّق دراسة التمثيلات. ولمّا كانت النصوص الأدبيّة الإفريقيّة على غاية من الأهميّة، ولمّا تجدّدت في الجامعة التونسيّة مناهج قراءتها، رأينا من الضروري أن يتضمّن مؤلَّفنا مقالات في الأدب. فكان أن درست ونّاسة النصراوي «كتابة الألم في ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح لـعلي الحصري (ت 488هـ/ 1095م)، باحثة في تحوّل الألم من تجربة انفعاليّة وإحساس ذاتي وإنساني إلى تجربة جماليّة إبداعيّة تُنْشئها اللغة ويَبْنِيهَا الإيقاع، ويَقُدُّها البيان. فالألم، موضوعا استعاريّا (objet métaphorique)، يبني عالما يكون البكاء فيه غناء والوجع مطربا. إنّ معاناة الفقد العميق جعلت الحصري مجدّدا في رثاء الأبناء الذي درست الباحثة معانيه وأشكاله وصوره. ومثلما يُطرب الشعر الحزين محرّكا أحاسيس القارئ بما فيه من طريف المعنى وجميل الصور وحسن الإيقاع، يُمْتِع النثر الذي يكون فيه الكلام لهوا واللذّة عالما. فقد اختارت هناء الطرابلسي أن تنظر في مظاهر اللهو وأشكاله في أدب إبراهيم الحصري (ت 413هـ/ 1061م) مهتمّة بلهو الكلام وهزله في الملح والنوادر، ومجالس اللهو وآدابها في زهر الآداب وثمر الألباب. إنّها تبحث في انتظام اللهو في قوانين تبني عالما لعبيّا حينا، كرنفاليّا حينا آخر، موظّفة الفلسفة وعلم اجتماع التفاعل وأنثرولوجيا اللعب. وهي مناهج سمحت لها بأن تبيـّن أقنعة الإنسان اللاهي وعوالمه الممكنة وأن توضّح كيف تسيّج القاعدة اللعب واللذّة عندما يتمّ حضور البعدين المعياري والأخلاقي في عالم اللعب. أمّا «أدب الباه: مصادر المعرفة واتجاهات التأليف» فهو المقال الأخير في هذا المؤلّف الجماعي. ويعود اهتمام نسرين السنوسي بالأدب الإيروسي إلى أنّ السّبق في الاحتفاء به، عن طريق و ضع مؤلّف خاصّ به دون غيره من الأغراض، يرجع إلى ثلاثة مؤلّفين من الأفارقة: التيفاشى (ت 651هـ/ 1253م) صاحب نزهة الألباب والتيجاني (ت 717هـ / 1317هـ) مؤلّف تحفة العروس، والنفــــــــــــزاوي (ق 9هـ / 15م) صاحب الروض العاطر. وقد عُدّ ذلك من أهمّ أغراض التأليف التي ميّزت الحياة الأدبيّة بإفريقيّة في العهد الحفصي. ودرست الباحثة خطاب الباه ومصادره وآليّات بنائه واختلاف الكتب الثلاث رغم وحدة موضوعها. وانتهت إلى فرضيّات ثلاث: ارتباط الأدب الإيروسي بعالم اللذّة الممكن، عالم الجنّة المقدّس، وتعلّقه بالعالم الأنثوي باعتبار الشوق قوّة أنثويّة لا تُشْبع، واقتران العالم الإيروسي بقوى الغيب والغياب كالسحر والحلم والموت والفزع والموت. ولم يفت الباحثة أن تفكّك القصص الإيروسي وعوالمه الممكنة، وأن تهتمّ ببعده التعليمي والنفعي. تلك هي مقالات هذا المؤلّف الجماعي التي شجّعنا الأستاذ عبد المجيد الشرفي على الإشراف عليه وإنجازه فاتحا لنا أبواب «بيت الحكمة» لتقديم «دراسات جديدة في حضارة إفريقيّة» ومناقشتها خلال يوم دراسيّ نُظّم يوم 2 فيفري 2018، ونَشْرِها. فإليه شُكري وشكر طلاّبه المساهمين في هذا الكتاب.
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|