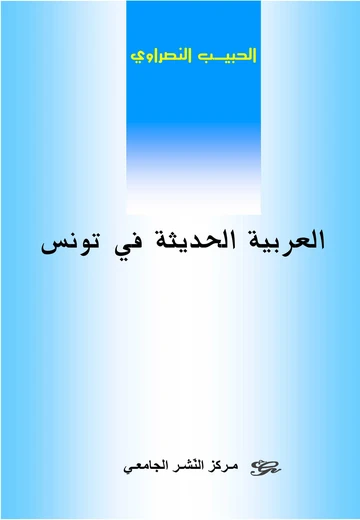العربية الحديثة في تونس
Détails de la publication
| Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|
| الباب الأول : مقدمات لدراسة الازدواج اللغوي | 5 | 74 | Published | |
| الباب الثاني أثر الازدواج اللغوي في العربية | 75 | 178 | Published | |
| الباب الثالث عربية تونس ومظاهر تطوّرها | 179 | 278 | Published | |
| فهرس المحتويات | 309 | 310 | Published |
مقدمات لدراسة الازدواج اللغوي – أثر الازدواج اللغوي في العربية – عربية تونس ومظاهر تط ورها.
Préface
تعدّ العربية اللغة المشتركة لمائات الملايين من المتكلمين، لا فقط في الرقعة المت ا رمية الأط ا رف الممتدّة من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا، بل في جميع أصقاع الدنيا، ويعود ذلك من ناحية، إلى ما حباها به الإسلام من منزلة رفيعة جعلتها تنتشر انتشاره وتثبت ثباته، ولكن أيضا إلى ما أتاحه لها الناطقون بها من تجدّد وتطوّر على امتداد عصورها. فقد ارتبط استخدامها عبر تاريخها، بعديد المجموعات المختلفة، وكلام هذه المجموعات يعكس بالضّرورة اختلافات بين العصور والثقافات والبيئات والأع ا رق، نابعة من مختلف وظائف اللغة، ومعبّرة عن تنوّع الحالات الاجتماعية التي تنعكس فيها. وكان من نتائج هذا الاحتكاك ما يعرف بالتداخل اللغويّ. ومن الطبيعي أن يكون لهذه اللغة التي أصبحت مشتركة بين شعوب شتى، روافدُ ذات ينابيع ضرورية لحياة هذه اللغة نفسها. فقد ارتبط استخدامها عبر تاريخها المديد، بعديد المجموعات المختلفة، وكلام هذه المجموعات يعكس بالضّرورة اختلافات ثقافية واجتماعية وعرقية، نابعة من مختلف وظائف اللغة، ومعبّرة عن تنوّع الحالات الاجتماعية التي تنعكس فيها. فإنّ أصل المعادلة تكمن في أنّ الحاجة إلى اللهجات في جميع اللغات هي حاجة داخلية ترتبط في الغالب بخصوصيات المتكلم للتعبير الشفويّ المباشر عن مواقف خاصة، أو عن حالات معيشية ترتبط به ارتباطا طبيعيا تلقائيّا، أما اللغة المشتركة فتأخذ المظهر العام، دون أن تستغني نهائيا عن الخاص. فهي تُستعمل غالبا في التعبير عن الجماعي والمشترك مثل قيمها ومناسباتها، وكذلك مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تستعمل في المفاهيم الفكرية العامة وفي تجريد القضايا في المستوى الذهني العام كالثقافة والفنون والدين.. فالعلاقة بين اللغة المشتركة واللهجة هي العلاقة بين الخاص والعام. هذا النوع من التداخل اللغوي قد يبدو أحيانا ضروريا، أمام عجز بعض اللغات على مواكبة سرعة التطوّر والتعبير عنه بأدواتها وأساليبها الخصوصية، لصعوبة قبول اللغة المشتركة لمظاهر التطور باليسر الذي يُحقِّق لها قَبولَ الجديد والتأقلم معه بالسرعة المطلوبة. في هذه الحالة قد تتحوّل اللهجات إلى وسائط بين اللغة الأم أو المشتركة، واللغات الحديثة المنتجة للجديد في مجالات المعرفة وغيرها، بسبب مرونتها وقدرتها على الاستعمال الحيّ. وهكذا يمكن أن تتحوّل هذه اللهجات إلى عنصر إث ا رء لغوي يحدّ من هيمنة الاقت ا رض من ناحية، ويكون في الوقت نفسه حلاّ لمعضلة التواصل وليس عائقا أمامه. في هذا الإطار تتنزّل مباحث هذا الكتاب الذي يهدف إلى وصف مظاهر الاحتكاك اللغوي في العربية، ويبحث خاصة في أثره في تكوين المستويات اللغوية، تطبيقا على إقليم بعينه، في ما أسميناه بالعربية الحديثة في تونس، منطلقين من فرضية ترى أنّ التداخل اللغوي ظاهرة لغوية يمكن أن تكون ضرورية للاطلاع على مظاهر تطور اللغات وكشف مبادئ ذلك التطور وقواعده. وهذا يحيلنا على مسألة التأصيل اللغوي، وهو مبحث متّصل بالعلوم التاريخية والاجتماعية يُطلعنا على أس ا ررٍ ومعلوماتٍ لا يُعثَر عليها دائما في النصوص الفصيحة المكتوبة، بل بالعودة أيضا إلى المنطوق المنسوب عادة إلى اللهجات أو العاميات. وهو جدير بالد ا رسة المعجمية، فإنّ فيه من ترسّبات الماضي ما يفسّر ظواهر الحاضر بعيدا عن التخمين والتوقّع. والحقيقة أنّ الإلمام بخصائص لهجات العربية ود ا رسة مكوناتها يفترض ظهور قواميس مختصة، ودارسات تأريخية وتأصيلية تكشف ما بين العربية ولهجاتها المختلفة من دينامية وتطوّر من حيث الأصوات والأبنية الصرفية وخاصة المعجم، لا من جهة الكمّ فقط ولكن من جهة الكيف أيضا ، أي تأصيل رصيد هذه اللهجات، ومعرفة أصوله ومدى صلتها بالعربية الفصيحة. لكنّ هذا أمر غير ميسور إلى اليوم في العربية، ولذلك سنستعين في بحثنا بعدد من الد ا رسات الحديثة م ا رعين في اختيارها ج دّ يتها وص ا رمتها العلمية، وصلتها المباشرة بالعربية المستعملة في تونس. والمتمعّن في هذا الجهد يدرك أنّه أ ري يُطرح ودع وة للحوار تُفتح، داخل المنظومة الثقافية العربية نفسها، بهدف الوقوف في وجه عواصف العولمة التي لا بقاء فيها إلا للقوي القادر على المنافسة بما تَو ف رَ له من شروط المناعة. ولن يتأتّى ذلك إلا 3 بالوصول إلى فهم مشترك لمكوّنات ال رصيد اللغوي ووظائف كلّ مستوى من مستوياته، وضرورة د ا رستها، والبحث في سبل تطوّرها وفق أسس البحث المعجمي الحديث. وهو النداء الذي وجّهه أحد المستشرقين الإسبان في محاضرة له بتونس عندما قال: "وعلى أهل اللغة ألاّ يضعوا ع ا رقيل لتطوير معجمها عن طريق توليد الألفاظ كلما دعت الحاجة إلى ذلك.. لكي تظ ل عربية المستقبل وليدة تشبه أمّها الشريفة التي ازدهت بها . أمّتها والإنسانية قاطبة" لكنّ منزلة التداخل اللغوي في الدّرس اللغوي العربي لا ت ا زل ضعيفة بسبب هيمنة مفهوم الفصاحة، فكثي ا ر ما عُدّ الرّصيد الأعجميُّ الذي أصبح جزءا من اللغة العربية غير ذي شأن، وقا ومته كتب اللحن وامتنع المعجم عن الاعت ا رف به، ورغم اتّساع الاقت ا رض في العصر الحديث ليشمل شتى العلوم والمعارف، فإنّه لا ي ا زل يُعامل معاملة العامي والمولّد، وهذا يؤدّي إلى إهماله واهمال دوره في تطوير اللغة. فاللغة بما لها من أثر في بنية الهوية وتنمية الفكر، تحتاج إلى تنوّع السياقات والاحتكاك بغيرها من اللغات. وهذا يستدعي الاعت ا رف بالنّصيب الذي تتحمّله اللغات الأخرى في رصيد اللغة المحلية، ومن ثمّ وظيفة التعدّد اللساني في العلاقات الاجتماعية وتطوّر المعارف. ولهذا نعالجه في هذا البحث باعتباره مظه ا ر لغويّا عاما، من ناحية، وباعتباره بابا من أبواب التوليد لا غنًى للغة عنه، من ناحية ثانية، فهو ظاهرة تُعدّ من الوسائل المهمّة في نموّ اللغة، وقد دلّت الملاحظة منذ القديم على أنّ اللغات يستعين بعضها بألفاظ بعض، حدث هذا في العربية الفصحى وفي عامياتها قديما ويحدث الآن. وتخصيص هذه الد ا رسة عنه ليس من باب توظيف التداخل اللغوي لإضعاف دور العربية الفصحى، والاقتصار على اعتبارها اللغة الرسمية الجامعة. بل إنّ الواقع يثبت أنّ احتكاك اللغات وتداخلها يمثّل الينابيع الثرّة لحياة اللغة المشتركة نفسها. إنّ .) 1 فيديريكو كوريينتي : من محاضرة له في رحاب جمعية المعجمية العربية بتونس )نوفمبر 2008 4 حاجة العربية إلى الازدواج اللغ وي كحاجة جميع اللغات الأخرى، وهي التعبير المباشر عن الواقع والالتصاق الضروريّ به، بينما تظلّ الحاجة إلى اللغة المشتركة قائمة لنقل المفاهيم الكبرى ومختلف مظاهر التحول الاقتصادي والثقافي والتطور الاجتماعي من الخاص إلى العام. إنّ التنصيص على هذه المبادئ العامة يهدف إلى تحديد نقاط دالة للملاحظة وللتفكير حول العربية والاحتكاك اللغوي في مجال مخصوص هو مجال الرصيد المعجمي، لنتبيّن : - كيف نمت هذه اللغة ؟ - هل يمكن تحديد بعض قواعد هذا النموّ ؟ - ما هي الوظيفة التي تلعبها هذه اللغة في علاقتها بالعربية الفصحى ؟ - هل لها أثر في الحياة الفكرية والثقافية ؟
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|