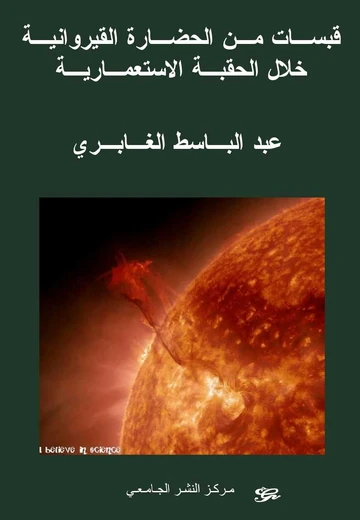Mots clés
قبسات من الحضارة القيروانية خلال الحقبة الاستعمارية
Détails de la publication
| Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|
| الباب الأول : الحضارة القيروانية في العهود الإسلامية التأسيسية | 7 | 102 | Published | |
| الباب الثاني : الحضارة القيروانية خلال الحقبة الاستعمارية | 103 | 186 | Published | |
| قائمة أهم المصادر والمراجع | 193 | 200 | Published | |
| الفهارس العامة | 201 | 229 | Published |
الحضارة القيروانية في العهود الإسلامية التأسيسية : النزعة الإنسانية في فكر احمد بن الجزار القيرواني – جدلية الثقافة والسياسة في القيروان خلال العهود الإسلامية التأسيسية – الحضارة القيروانية خلال الحقبة الاستعمارية : الصحافة الأدبية خلال فترة الاستعمار الفرنسي – دور المخيال في صياغة صورة القيروان لدى أدبائها خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
Préface
إذا كان حدث إعلان القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم قد شغل الساحة الإعلامية على مدار سنة كاملة (سنة 2009 ) في مختلف وسائل الإعلام سواء السمعية أو المرئية أو المكتوبة فإ ن هذه الوسائل قد نقلت نقلا سريعا خاطفا للأنشطة والتظاهرات وبعض الندوات العلمية في إطار البرامج الإخبارية غالبا أو في البرامج الثقافية التي تذاع بعد التاسعة ليلا أحيانا، وهو ما أفرغ تلك التظاهرة من أبعادها ومقاصدها الحقيقية التي تتمثّل – حسب ما نعتقد- في ترسيخ الوعي بعمق الشخصية التونسية وأصالة هويتنا. وإن تخصصنا في القضايا الحضارية التي شغلت الفكر التونسي خلال طور الاستعمار الفرنسي هو الذي نبهنا إلى ضرورة التص دي لذلك المجال التاريخي والمعرفي، فعلى سبيل الذكر كشفت لنا رسالتنا المتعلقة بصوت الطالب الزيتوني بروز بعض الرموز الزيتونية القيروانية التي أسهمت في تجذير وعي طلبة الزيتونة بضرورة تطوير منظومة مؤسستهم في جلّ المجالات تقريبا ولا سيما المجال التربوي والتنظيمي مثل الشيخين محمد النخلي ومحمد بوشربية. وبما أ ن مجال الأطروحة لم يتسع إلى تفصيل جميع تلك القضايا والتع رض لها فقد كان هذا الكتاب وتحديدا في فصله المتعّلق بالصحافة الأدبية بالقيروان خلال الحقبة الاستعمارية امتدادا لتلك الرسالة وتوسعة لبعض إشكالياتها. ولئن تبدو فصول كتابنا متباينة في ما بينها من حيث حجمها ومواضيعها وعلاقتها ببعضها البعض في مستوى الظاهر فإن ذلك لا يعكس إ ّ لا جانبا واحدا من الحقيقة، إذ نعتقد أن مادة الكتاب متجانسة ومتواشجة في أكثر من مستوى، ويمكن تلخيصها في العلامات التالية : + مستوى الموضوع : تشترك جميع الفصول في إثارتها قضايا مّتصلة بالحضارة القيروانية في أهم نواحيها الثقافية والسياسية والاجتماعية، وإذا كنّا قد صرحنا ببعضها فإن جانبا هاما منها ظلّ مضمرا ضمنيا لا يعسر على القارئ الفطن الاهتداء إليه، كما أن التقيد بموضوع واحد لا يعني أبدا تساوي جميع عناصره المتفرعة عنه في حجمها ووظائفها. ولذلك فإ ن التباين أمر ضروري في بعض الأحيان. ومن العلامات التي يمكن بها تقييم قدرات الباحثين ومؤهلاتهم مدى 2 نجاحهم في تنظيم مادة بحوثهم بطريقة منهجية تتناغم وتتجانس مع جميع مراحل البحث. + مستوى الامتداد الزمني : إن الدراسة الشاملة المفصلة لحقبة تاريخية معينة تستعصى وتصعب حتّى على المختصين في المجال التاريخي لذلك غالبا ما يقع الاكتفاء بنماذج معينة من أهم خصائصها أنّها جامعة شاملة لأهم التقاسيم المميزة لتلك الحقبة. وفي صورة وجود إشكال ما تنهض البحوث اللاحقة له بضبط ذلك الإشكال وتبديده. وبالنسبة إلى المجال الزمني لبحثنا فقد حصرناه في بابين : باب أول اقتصر على العهود التأسيسية للحضارة القيروانية باعتبار أنّه يستحيل أن تبزغ حضارة ما بمعزل عن رواسبها وجذورها، ولا سيما عندما يتعّلق الأمر بالحديث عن حضارة في حقبة استعمارية تحيل في المخيال غالبا على معاني الانحسار والتراجع والانهيار وهو موضوع الباب الثاني. وأما بالنسبة إلى الفصول الفرعية فقد انطلقنا مما هو إنساني وكوني، ثم تطرقنا إلى فعالية ثنائية الثقافة والسياسة في حيز زمني استغرق عهود الدول الإسلامية الأولى التي تعاقبت على سدة الحكم بالقيروان، ثم تعرضنا إلى الصحافة الأدبية خلال فترة الاستعمار الفرنسي باعتبار أن الصحافة هي المرآة العاكسة لصيرورة حضارة ما ورقيها. وهو ما سمح لنا بالتعرف على عديد الأدباء فرصدنا جانبا مشتركا بين نتاجهم الأدبي من ناحية الأدوات الفنية ومتعّلقا بالمخيال أساسا لذلك حاولنا دراسته وتحليله تحليلا يتجاوز الجوانب الفنية إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والحضارية. + مستوى المنهج : تشترك جميع فصول الكتاب في بعض المصادر الأساسية في ما يتعّلق بضبط أهم المفاهيم الأساسية (الثقافة، السياسة، الإنسانية...) مثل دائرة المعارف الكونية في نسختها الفرنسية، وهو طرح لا يخلو من طرافة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّه تقريبا ولأول مرة يتم تعريب قسم من تلك المفاهيم من ذلك المصدر المستثاق به علميا، رغم أن تعريبنا تعريب توظيفي بمعنى أّنه اقترن بالسياقات التي ورد فيها بالنسبة إلى بحوثنا، ثم بعد أن نتشبع بالمفهوم في مجاليه المعرفيين العربي والغربي (الفرنسي أساسا) نحاول استقراء تجّلياته ومجالاته في مدونتنا المدروسة لنخلص في الختام إلى تقييمه من خلال تحديد أبعاده ووظائفه، وهي بنية تشترك فيها جميع فصول الكتاب ثقريبا. 3 ولئن أشرنا إلى بعض محتويات كتابنا في ما سلف من هذه المقدمة فإنّنا مدعوون إلى تفصيل ذلك بطريقة تيسر الإلمام بمحتواه لذلك نحن مدعوون إلى التذكير بأن كتابنا يتأّلف من بابين يتفرع كلّ واحد منهما إلى فصلين. وسمنا الباب الأول بحضارة القيروان خلال العهود الإسلامية التأسيسية، وقد ضم فصلين: فصل أول تعّلق بالنزعة الإنسانية في فكر أحمد بن الجزار القيرواني 1 الذي قد يبدو لقارئه من خلال عنوانه اجترارا وحشوا لكثرة ترديد هذا الموضوع في الخطاب الإعلامي والثقافي منذ أن ترجمت أطروحة المفكّر الجزائري محمد أركون إلى العربية بعنوان "النزعة الإنسانية في الفكر العربي" فإنّنا ودون مغالاة أو مبالغة يمكننا الإقرار أنّه لا وجود إلى حد هذه اللحظة – حسب علمنا واطلاعنا – لدراسة حقيقية ومعمقة تحاول توضيح مفهوم "النزعة الإنسانية" بمنأى عن الانتقائية والاختزالية، وإلاّ كيف يمكن أن نفسر التباين الصارخ والبون الشاسع بين تعريف لمادة "النزعة الإنسانية" في (jean claude margolin) جون كلود مارقولان دائرة المعارف الكونية مع ما حبره جلّ الكتّاب العرب في هذا الموضوع بالذات. فالمطّلع للتعريف الفرنسي سالف الذكر يحصل على فوائد جمة وتشبع لغزارة المادة والمعلومات الواردة فيها رغم مشقّة التعريب وبعض التناقضات التي لا تقّلل من قيمة محتوى المادة باعتبار أنّها إفراز حتمي لتطور المفهوم وصيرورته منذ ما يقارب الخمسة قرون (من القرن السادس عشر إلى أواسط القرن العشرين). وقد حاولنا إثبات تجذّر تلك النزعة في تراثنا منطلقين من فكر أحمد بن الجزار الذي عكسته مؤّلفاته دون أن ننزلق في معايب الإسقاط ومخازيه. وتعرضنا في الفصل الثاني من نفس الباب إلى جدلية الثقافة والسياسة ضمن نفس تلك الفترة التاريخية المدروسة (العهود الإسلامية التأسيسية). وقد اعتمدنا على كتابي "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذارى و"رياض -1 ق دم هذا البحث في الأصل مداخلة ضمن الندوة الدولية للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الزيتونة والجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة التي كان موضوعها المدرسة الطبية القيروانية وموقعها في الطب العربي الإسلامي أيام 17 و 19 نوفمبر 2009 بفضاء مركز الدراست الإسلامية. وقسم هام من هذه الدراسة نشر في مجلة المشكاة الصادرة عن جامعة الزيتونة. 4 النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية" لأبي بكر المالكي لمحاولة إعادة النظر في مدى صحة ربط الإبداع أو النهضة الفكرية بالعوامل السياسية، كما حرصنا على تقييم فعالية النخبة القيروانية وعطائها بالنسبة إلى مجتمعها وأفق انتظار واجبها إلى منتصف القرن الخامس هجري أي من سحنون وأسد بن الفرات إلى أبي بكر المالكي وابن رشيق وابن شرف مرورا بجبلة بن حمود وأبي سعيد بن الحداد. أما في الباب الثاني الموسوم بحضارة القيروان خلال الحقبة الاستعمارية فقد ، تطرقنا في فصله الأول إلى الصحافة الأدبية القيروانية خلال المرحلة الاستعمارية 1 ويعتبر هذا البحث طريفا في بابه، جديدا في مضمونه استلزم منّا ما يزيد عن الستة أشهر من التردد على الأرشيف الوطني وقسم الدوريات بالمكتبة الوطنية باعتبار أن الصحافة القيروانية كانت قطبا هامشيا خلال الحقبة الاستعمارية. ولأ ول مرة يقع إبرازالنخبة القيروانية التي برزت خلال الحقبة الاستعمارية أمثال الشيخ عمر 1941 ) والشاعر محمد نجاحهم في تنظيم مادة بحوثهم بطريقة منهجية تتناغم وتتجانس مع جميع مراحل البحث. + مستوى الامتداد الزمني : إن الدراسة الشاملة المفصلة لحقبة تاريخية معينة تستعصى وتصعب حتّى على المختصين في المجال التاريخي لذلك غالبا ما يقع الاكتفاء بنماذج معينة من أهم خصائصها أنّها جامعة شاملة لأهم التقاسيم المميزة لتلك الحقبة. وفي صورة وجود إشكال ما تنهض البحوث اللاحقة له بضبط ذلك الإشكال وتبديده. وبالنسبة إلى المجال الزمني لبحثنا فقد حصرناه في بابين : باب أول اقتصر على العهود التأسيسية للحضارة القيروانية باعتبار أنّه يستحيل أن تبزغ حضارة ما بمعزل عن رواسبها وجذورها، ولا سيما عندما يتعّلق الأمر بالحديث عن حضارة في حقبة استعمارية تحيل في المخيال غالبا على معاني الانحسار والتراجع والانهيار وهو موضوع الباب الثاني. وأما بالنسبة إلى الفصول الفرعية فقد انطلقنا مما هو إنساني وكوني، ثم تطرقنا إلى فعالية ثنائية الثقافة والسياسة في حيز زمني استغرق عهود الدول الإسلامية الأولى التي تعاقبت على سدة الحكم بالقيروان، ثم تعرضنا إلى الصحافة الأدبية خلال فترة الاستعمار الفرنسي باعتبار أن الصحافة هي المرآة العاكسة لصيرورة حضارة ما ورقيها. وهو ما سمح لنا بالتعرف على عديد الأدباء فرصدنا جانبا مشتركا بين نتاجهم الأدبي من ناحية الأدوات الفنية ومتعّلقا بالمخيال أساسا لذلك حاولنا دراسته وتحليله تحليلا يتجاوز الجوانب الفنية إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والحضارية. + مستوى المنهج : تشترك جميع فصول الكتاب في بعض المصادر الأساسية في ما يتعّلق بضبط أهم المفاهيم الأساسية (الثقافة، السياسة، الإنسانية...) مثل دائرة المعارف الكونية في نسختها الفرنسية، وهو طرح لا يخلو من طرافة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّه تقريبا ولأول مرة يتم تعريب قسم من تلك المفاهيم من ذلك المصدر المستثاق به علميا، رغم أن تعريبنا تعريب توظيفي بمعنى أّنه اقترن بالسياقات التي ورد فيها بالنسبة إلى بحوثنا، ثم بعد أن نتشبع بالمفهوم في مجاليه المعرفيين العربي والغربي (الفرنسي أساسا) نحاول استقراء تجّلياته ومجالاته في مدونتنا المدروسة لنخلص في الختام إلى تقييمه من خلال تحديد أبعاده ووظائفه، وهي بنية تشترك فيها جميع فصول الكتاب ثقريبا. ولئن أشرنا إلى بعض محتويات كتابنا في ما سلف من هذه المقدمة فإنّنا مدعوون إلى تفصيل ذلك بطريقة تيسر الإلمام بمحتواه لذلك نحن مدعوون إلى التذكير بأن كتابنا يتأّلف من بابين يتفرع كلّ واحد منهما إلى فصلين. وسمنا الباب الأول بحضارة القيروان خلال العهود الإسلامية التأسيسية، وقد ضم فصلين: فصل أول تعّلق بالنزعة الإنسانية في فكر أحمد بن الجزار القيرواني 1 الذي قد يبدو لقارئه من خلال عنوانه اجترارا وحشوا لكثرة ترديد هذا الموضوع في الخطاب الإعلامي والثقافي منذ أن ترجمت أطروحة المفكّر الجزائري محمد أركون إلى العربية بعنوان "النزعة الإنسانية في الفكر العربي" فإنّنا ودون مغالاة أو مبالغة يمكننا الإقرار أنّه لا وجود إلى حد هذه اللحظة – حسب علمنا واطلاعنا – لدراسة حقيقية ومعمقة تحاول توضيح مفهوم "النزعة الإنسانية" بمنأى عن الانتقائية والاختزالية، وإلاّ كيف يمكن أن نفسر التباين الصارخ والبون الشاسع بين تعريف لمادة "النزعة الإنسانية" في (jean claude margolin) جون كلود مارقولان دائرة المعارف الكونية مع ما حبره جلّ الكتّاب العرب في هذا الموضوع بالذات. فالمطّلع للتعريف الفرنسي سالف الذكر يحصل على فوائد جمة وتشبع لغزارة المادة والمعلومات الواردة فيها رغم مشقّة التعريب وبعض التناقضات التي لا تقّلل من قيمة محتوى المادة باعتبار أنّها إفراز حتمي لتطور المفهوم وصيرورته منذ ما يقارب الخمسة قرون (من القرن السادس عشر إلى أواسط القرن العشرين). وقد حاولنا إثبات تجذّر تلك النزعة في تراثنا منطلقين من فكر أحمد بن الجزار الذي عكسته مؤّلفاته دون أن ننزلق في معايب الإسقاط ومخازيه. وتعرضنا في الفصل الثاني من نفس الباب إلى جدلية الثقافة والسياسة ضمن نفس تلك الفترة التاريخية المدروسة (العهود الإسلامية التأسيسية). وقد اعتمدنا على كتابي "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذارى و"رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية" لأبي بكر المالكي لمحاولة إعادة النظر في مدى صحة ربط الإبداع أو النهضة الفكرية بالعوامل السياسية، كما حرصنا على تقييم فعالية النخبة القيروانية وعطائها بالنسبة إلى مجتمعها وأفق انتظار واجبها إلى منتصف القرن الخامس هجري أي من سحنون وأسد بن الفرات إلى أبي بكر المالكي وابن رشيق وابن شرف مرورا بجبلة بن حمود وأبي سعيد بن الحداد. أما في الباب الثاني الموسوم بحضارة القيروان خلال الحقبة الاستعمارية فقد ، تطرقنا في فصله الأول إلى الصحافة الأدبية القيروانية خلال المرحلة الاستعمارية 1 ويعتبر هذا البحث طريفا في بابه، جديدا في مضمونه استلزم منّا ما يزيد عن الستة أشهر من التردد على الأرشيف الوطني وقسم الدوريات بالمكتبة الوطنية باعتبار أن الصحافة القيروانية كانت قطبا هامشيا خلال الحقبة الاستعمارية. ولأ ول مرة يقع إبرازالنخبة القيروانية التي برزت خلال الحقبة الاستعمارية أمثال الشيخ عمر 1941 ) والشاعر محمد - العجرة ( 1872 -؟) والأديب صالح السويسي ( 1878 1946 ) والأديب محمد الحليوي - 1952 ) وعلي العريبي ( 1911 - بوشربية ( 1903 ...(1978-1907) وقد كانت قراءتنا لسيرهم مندرجة في سياق تحديد الوظائف التي اضطلعت بها الصحافة القيروانية مثل الوظائف التأصيلية والإبداعية والنقدية والحضارية. ولم يكن تحديد تلك الوظائف بالأمر اليسير، بل قامت على جهد غير قليل ونفس طويل باعتبار أنّنا درسنا نصوصا صحفية أصلية مضى على صدورها ما يقارب القرن من الزمن. ومن أهم الصحف التي برزت في تلك الحقبة التاريخية يمكن أن نذكر: * باللغة الفرنسية - الاتحاد القيرواني : صدر أول عدد منها يوم 1 جوان 1908 وآخر عدد . يوم 25 جويلية 1909 -جريدة القيروان : صدر أول عدد يوم 23 فيفري 1923 وآخرعدد يوم . يوم 29 جوان 1929 * باللغة العربية - جريدة القيروان : يعتبر صدورها الانطلاقة الحقيقية للصحافة القيروانية . صدر أول عدد منها يوم 17 أوت 1920 وآخر عدد يوم 28 ديسمبر 1924 - جريدة صبرة : تعكس المستوى الراقي الذي ارتقت إليه الطاقات التعبيرية التي تتميز بها النخبة القيروانية بدليل انضمام بيرم التونسي إلى أسرة تحريرها . صدر أول عدد يوم 16 ديسمبر 1936 وآخر عدد يوم 16 أوت 1939 أما في الفصل الثاني فقد درسنا دور المخيال في صياغة صورة القيروان لدى أدبائها خلال نفس تلك المرحلة التاريخية 1، وهو امتداد للبحث السالف وتطوير له. ينطلق هذا البحث من حقيقة القيروان المدينة الرمزالتي ظّلت محتفظة في مخيال شعرائها ووجدانهم بصورة زاهية تحيل على معاني الأصالة والقداسة والعتاقة رغم أفول زهوتها الحضارية وقوتها المادية. وقد كانت استعادة تلك الصورة المفقودة بفضل آلية المخيال الذي يعرفه الأنثربولوجي الفرنسي جيلبار بأنّه الآلية التي بواسطتها نستعيد الأحداث التي يستحيل (gilbert durand) ديران علينا استعادتها "لحما وعظما" مثل ذكريات الطفولة وعالم الآخرة.... وقد انتظم بحثنا سالف الذكر في ثلاثة محاور أساسية : محور أ ول بسطنا فيه علاقة الصورة بالمخيال بعد أن عرفنا كليهما تعريفا دقيقا وأوضحنا العلاقات الجامعة بينهما من الناحية النظرية، ثم في محور ثان استنبطنا تجليات صورة القيروان في مجاميع أدبائها فكان أن ميزنا بين صورة موجودة وصورة مفقودة وصورة منشودة. أما في المحور الثالث وهو صفوة الفصل فقد أثبتنا فيه حقيقة الدور الذي نهض به المخيال في صياغة صورة القيروان فانتهينا إلى إلى أ ن المخيال آلية توازن نفسي واجتماعي باعتبار أنّه يمكّن من تجاوز عوائق الزمن والفناء والموت، بل أكثر من ذلك يساعد على استثمار "الرأسمال الرمزي" إذا انعدم أو قلّ الرأسمال المادي فيعيد حفز الهمم وترميم الذات ويدعم تمركزها حول نواتها وهويتها. ولا تفوتنا الإشارة في خاتمة هذه المقدمة إلى أنّه كانت لدينا رغبة صادقة في إثراء كتابنا بنماذج أخرى من الحضارة القيروانية خلال الحقبة الاستعمارية، ولاسيما بعد معرفتنا بأن الجزء الثاني من مخطوط "مورد الضمآن" للشيخ محمد الجودي يضم أكثر من سبعين ترجمة لمعاصريه ولكن تعذّر ذلك لأسباب تتجاوزنا
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|